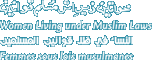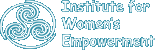مليكة مقدّم في «رجالي»: يوميّات مستعجلة عن جرح دفين اسمه الحرية
الكاتبة الجزائرية مليكة مقدم، غادرت الوطن لتصبح طبيبة، ثم عادت إليه «كاتبة». وبصدور روايتها «رجالي»، تكون قد أنجزت ثلاثيتها «الرجال الذين يمشون» (1997) التي عرفت انتشاراً واسعاً في باريس، و«هول المتمردين» (2003) وأخيراً «رجالي» (2005). تصوّر الكاتبة عالماً ذكورياً فجّاً بكل تفاصيله، هذا العالم التي تعمد الى فضحه بعدما رفضت أن تخضع لتقاليد القبيلة في تدجين النساء.
العلاقة بالأب الفظّ في «رجالي»، ستحكم نظرة الراوية إلى الآخر، وتهيمن على أي عاطفة تجمعها به مهما كان نوعها. هكذا، ستراقب هذه الأخيرة عشاقها وأصدقاءها، وتتعلق بهم، لكنها ستتمالك نفسها كي لا تهرع إليهم... ليكون القرار دائماً في يدها. يقودها ذلك إلى خوض علاقات متعددة، محاولة أن تثبت لنفسها في كل مرة أنّها حرة، وقادرة على مراقبة الآخرين وهم يندفعون نحوها... فيما تتمتع هي بنوع نادر من الخلاص العاطفي والقدرة على البتر والمضي قدماً. تقول الراوية لأبيها: «فارقتك لأتعلم الحرية، الحرية حتى في عشق الرجال. وأدين لك بأنّني لطالما عرفت أن أنفصل عنهم حتى حين كنت مفتونة ومتدلهة بهم». في سردها هذه التفاصيل الخاصة، لا تمثّل مليكة أي استثناء. إذ إنّ كاتبات كثيرات لجأن في السنوات (العقود؟) الماضية إلى تناول الجنس والعلاقات العاطفية... لكن كثيراً من الروايات التي أُنتجت يحمل طابع البريد المستعجل، المتوجّه إلى قارئ نهم للتلصّص على غراميات المرأة الشرقية. وإن كان هذا الكلام لا ينطبق بحرفيته على «رجالي»، لكنه ليس ببعيد عنها... إذ يضعنا الكتاب أمام تساؤلات من هذا النوع. فبطلة مقدّم مشاغبة ناجحة، تستظهر مشاعرها العنيدة المتحفزة، وتتحيّن الفرصة لانتزاع الآخر العزيز من حياتها، وخوض مغامرة عاطفية جديدة تكفل لها حلقة مستمرة من الحرية. وتلك الحرية تتجسّد في الجنس أولاً، كأنّها في كل مرة تعيد الإصغاء فيها إلى ذلك النداء البري الطالع من الأعماق، ليصبح عنواناً يختصر عوالمها. لا تتعلق تفاصيل الرواية بقصّة واحدة، يمكن تتبّع خيوطها وشخوصها وأحداثها. فلا رابط زمنياً متسلسلاً بين الأحداث. لكن فيها ما يدركه القارئ منذ البداية، ألا وهو تتبع شخصية المرأة المتمردة العابثة والرافضة، في سعيها إلى إيجاد منفذ لامرأة أخرى دفينة في داخلها، تحاول أن ترضي أناها. تحاول أن تنزع عنها الكثير من الأوهام الاجتماعية التي تنطوي عليها القيم والأعراف الاجتماعية والدينية في الجزائر. وعلى رغم المحاولات المستمرة لطمس معالم تلك المرأة، إلّا أنها تعاود الظهور بقوة للتعلّق بحلمها: إنّ يوماً سيأتي، تجد خلاصها في بلاد أخرى، حيث الرجال الشقر ذوو القامات الطويلة الذين لا ينتمون إلى منطق القبيلة، ولا يدافعون عن ثقافة قبلية، ذكوريّة، صحراوية تستهدفها وتستهدف بنات جنسها. لا تتنصّل الراوية أبداً من حضور شخصية المؤلف، بل تقدمها وتبرزها لتؤكد شرعيتها، وتترك الرغبات العارمة والمكبوتة تضيف وتحذف بلغة لم تساير القصة. إذ جاءت هذه اللغة مباشرةً ومحافظةً، على عكس سير الحكايات، فخلت الرواية تماماً من أي لغة جريئة أو فاضحة أو حتى حميمة. ظلت الإشارات الجنسية خجولةً ومستعجلة،ً واللغة تقليدية مع ومضات شعرية هنا وهناك. لكن الكاتبة قدمت كذلك شخصية امرأة ذات حواسّ ناضجة، غير معطّلة، ليس لديها مخاوف شخصية من المجازفة. امرأة قادرة على الابتهاج، والاستمتاع بالإحساس، خارج الحدود الاجتماعية والدينية التي تجعل منها كائناً يتضوّر جوعاً للحياة، ويخطط للخلاص عبر الهروب الذي سيكلفها قطيعة مع الأهل والوطن ستدوم طويلاً، حيث ستعيش في فرنسا بخبرة المهاجر والإحساس بالتعلّق بماض لا يمكن الرضى عنه. تنتهي الحال بالراوية وحيدة وقد انفصلت عن زوجها الفرنسي الذي خانها مع شقيقتها. تنتقل إلى علاقات متعددة تنتهي بها وحيدة منذ 11 عاماً بعدما وقعت في هوى رجل كندي لم يبادلها الحب. فتغدو مجرد كاتبة مهاجرة مطمئنة، في مكان بديل، وغريبة في وطنها الأم. هكذا تجد الأمان والهدوء في عالمها الداخلي، بعد الخسارات العاطفية الجسيمة، وتقتنع بالعزلة. لماذا كتبت مليكة مقدم هذه الرواية؟ هل حملت هذه القصص العاطفية ما يستحق أن تسرد من أجله؟ في الحقيقة أنّها تبرر كتابة هذه الرواية منذ البداية فتقول: «أكتب لأنّ الأرض اتخذت تلك الصورة، ورائحة الجثث والدم، ولئلا أصاب باليأس». وهي تكتب أيضاً عن الرجال الذين عشقتهم بملء حريتها، لتتحدّى الملتحين الذين «تضاهي أنيابهم في طولها الليل الجزائري الدموي».
قد تكون الكاتبة نجحت في إغاظة الملتحين، لكن إلى أي مدى يمكن الكتابة أن تكون عرض حال، وتصفية حسابات مع الماضي، وتحدياً للتاريخ والناس؟ هل نجحت حقاً في تقديم عمل إبداعي مدهش، وتجربة وجوديّة، ونموذج لامرأة خارجة على قوانين الجماعة؟ أم أنّها تركت لنا يوميات مستعجلة، عن المرأة والجسد... وجرح دفين اسمه الحرية؟
عدد الخميس ٢٢ تشرين الثاني